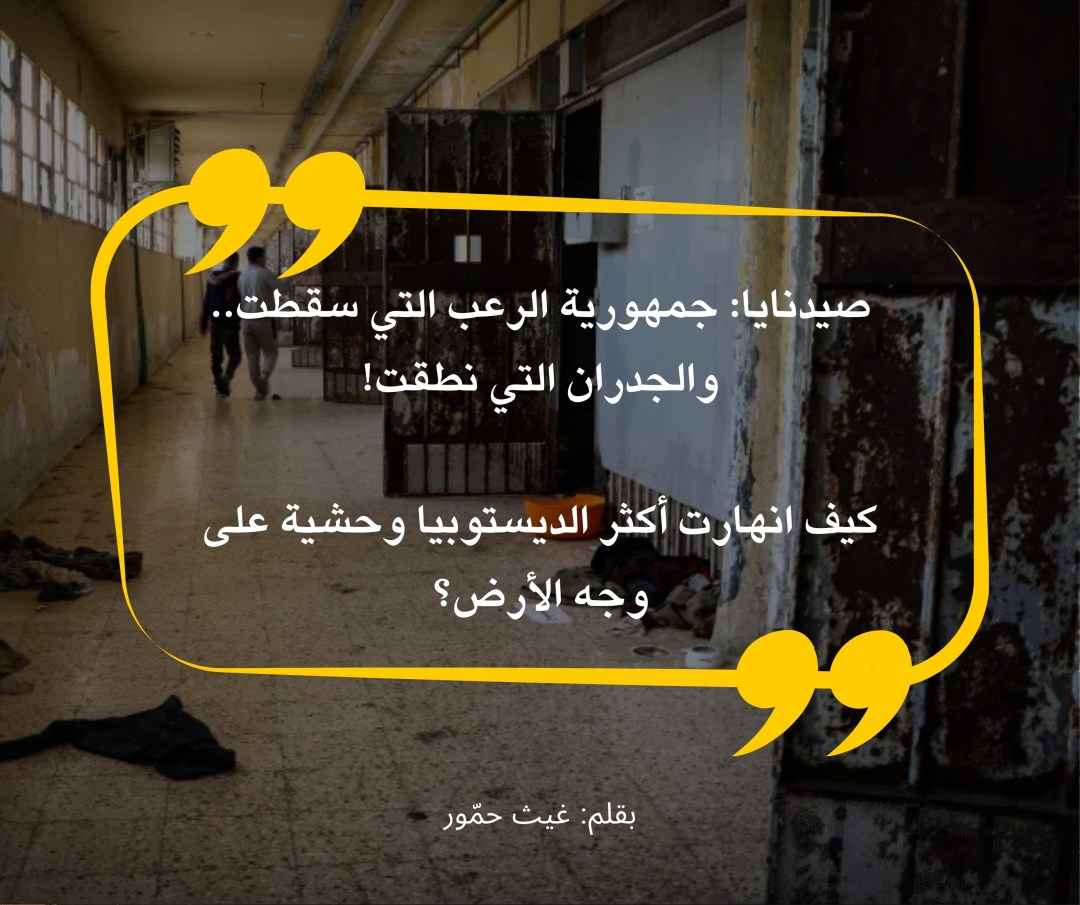(كيف انهارت أكثر الديستوبيا وحشية على وجه الأرض؟)
لأكثر من نصف قرن، وقفت “جمهورية صيدنايا المستقلة” كأكثر بقعةٍ سوداوية في سوريا، حيث لا قوانين ولا عدالة، وحيث كان الموت هو سيد الأحكام. لم يكن هذا المكان مجرد سجن، بل كان دولة داخل الدولة، نظامًا قائمًا بذاته، يُديره حراسٌ بلا وجوه، ويُحكمه الخوف وحده. لكن في النهاية، وككل الأنظمة المبنية على الرعب، سقط.
العاصمة السابقة: الزنزانة رقم صفر
في ذلك الوقت، لم يكن لصيدنايا رئيسٌ رسمي، ولا برلمانٌ، ولا وزارات. لم يكن هناك شيء سوى وزير الظلام، ذاك الذي لم يحمل اسمًا لكنه حمل مصير آلاف المعتقلين بقبضة من حديد. توسعت حدود “الجمهورية” كلما امتلأت الأقبية بأجسادٍ أُنهكت تحت التعذيب، وكلما اختفى المزيد من المعارضين في ظلامها.
حينها، لم يكن للزنازين أبوابٌ تُفتح للخارج، ولم يكن للمساجين أسماء، فقط أرقام منحوتة على جدران متآكلة من الرطوبة والدم.
النشيد الوطني: الصمت الأبدي
لم يكن هناك نشيد رسمي يُعزف في صيدنايا، فقد كانت الموسيقى الوحيدة هي أصوات العظام وهي تُكسر، والصرخات التي لا تجد من يسمعها. في تلك الجمهورية، كان الصمت أكثر لغات العالم تداولًا، ليس لأنه اختيار، بل لأن الكلمات كانت تُكلف حياة صاحبها.
العملة الرسمية: الدم
حين كان المعتقل يدخل إلى صيدنايا، كان يدفع ضريبة الدخول من جسده، وأحيانًا من روحه. لم تكن هناك سجلات مالية، بل سجلات تعذيب، ولم يكن هناك اقتصاد سوى ذاك المبني على الرشاوى التي قد تشتري للمرء رشفة ماء أو تأجيلًا ليومٍ إضافي في الحياة.
أما الذين أفلسوا، فقد تم تحويلهم إلى ما كان يُعرف آنذاك بـ**”غرفة التصفية”**، حيث اختفى آلاف البشر دون أثر، دون شواهد قبور، ودون أن يُسجّل موتهم في أي وثيقة رسمية.
التوقيت الرسمي: ساعة القيامة
في تلك الحقبة، لم يكن الزمن في صيدنايا يسير كما يسير في باقي بقاع الأرض. لم يكن هناك فجرٌ ولا غروب، فقط امتداد لا نهائي للوقت، حيث يمكن أن تمر لحظة وكأنها ألف عام، ويمكن أن يمضي العمر بأكمله وكأنه لم يكن. لم تكن هناك ساعاتٌ على الجدران، فالمقياس الوحيد للزمن كان عدد اللكمات وعدد الليالي التي مرت دون أن يُنادى الاسم إلى غرفة التعذيب.
السياحة في صيدنايا: المغامرة التي لا يعود منها أحد
في ذلك الزمن، لم يكن يحتاج أحدٌ إلى تأشيرة دخول إلى هذا الجحيم. كان يكفي أن يُتهم شخصٌ ما بالتفكير، بالهمس، بالحلم، ليُحجز له سريرٌ بين جدرانٍ سوداء لا تُخبر أحدًا بسر من ينام فيها.
كان “الوافدون الجدد” يستقبلون بإجراءات الترحيب التقليدية: ضربٌ، ثم تجريدٌ من كل ما يملكون، ثم انتظارُ دورهم في غرفة التحقيق. لم يكن هناك خروج، إلا بأحد طريقتين: ملفوفًا بقطعة قماش رمادية، أو محطّمًا بما يكفي ليخرج بلا عقل ولا ذاكرة.
السقوط: كيف انتهت جمهورية صيدنايا؟
لكن كما سقط النظام، سقطت معه جمهورية الظلام. حين تحررت الزنازين أخيرًا، لم يكن سكانها كما كانوا قبل اعتقالهم. لم يخرجوا مبتهجين، بل خرجوا كالأشباح، غير مصدقين أن الحياة لا تزال موجودة خارج هذه الجدران.
حين دخل الصحفيون والمحققون إلى الداخل، لم يجدوا فقط سجنًا، بل أكبر مسرح جريمة في العصر الحديث. وجدوا وثائق متروكة على مكاتب غطاها الغبار، ملفات تحوي أسماءً لم تعد موجودة، وغرفًا امتصت صرخاتٍ لم يعد أحدٌ قادرًا على تمييزها.
أحد الصحفيين كتب حينها: “لم يكن هذا مجرد سجن. كان مصنعًا للموت، آلةً صُممت لابتلاع البشر وتحويلهم إلى ظلال”.
ما بعد السقوط: هل انتهى الرعب؟
تحررت صيدنايا، لكن السؤال ظلّ عالقًا: هل يمكن لمن عاش في هذا الرعب أن يعود إنسانًا من جديد؟
البعض حاول النسيان، البعض حاول العيش، والبعض ظلّ يزور أطلال السجن، يحدّق في الجدران المتشققة، كأنه ينتظر أن يسمع صدى الأصوات التي لم تجد من يسمعها يومًا.
أما السؤال الأكبر، فهو: هل كانت صيدنايا مجرد مكان، أم أنها كانت فكرة؟ وإذا كانت فكرة… هل يمكن أن تولد من جديد تحت مسمى آخر، في مكان آخر؟
لقد سقطت جمهورية الخوف… لكن هل انتهى زمن الخوف؟